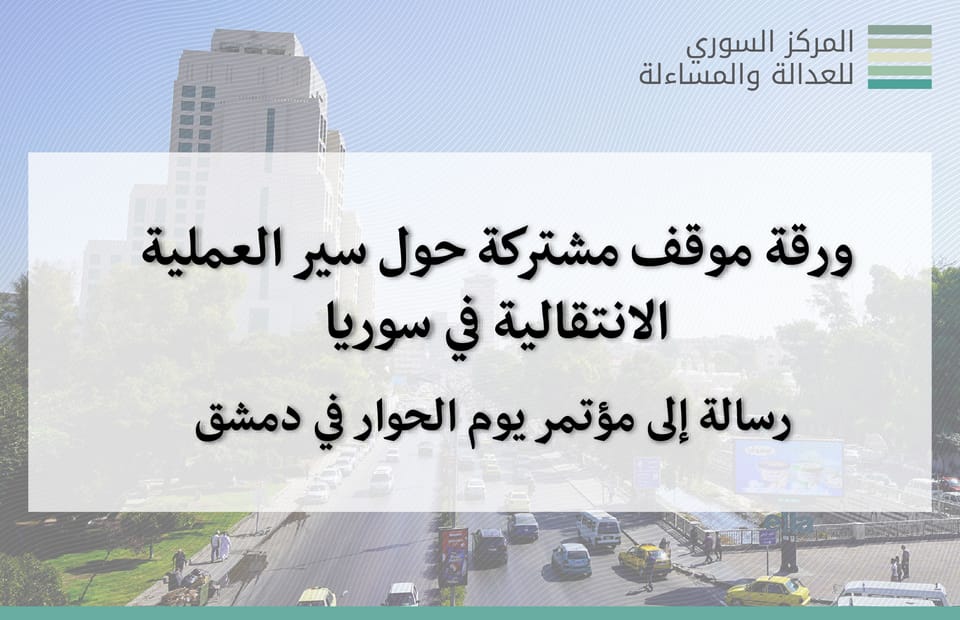
ورقة موقف مشتركة حول سير العملية الانتقالية في سوريا: رسالة إلى مؤتمر يوم الحوار في دمشق
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
مع اقتراب مرور عام على سقوط نظام الأسد وإنطلاق المرحلة الانتقالية، تجد سوريا نفسها أمام مشهد سياسي شديد التعقيد وبنية اجتماعية متصدعة، تفاقمت هشاشتها بفعل موجات العنف المركّز والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يتقدّم المسار السياسي الداخلي ببطء شديد، في مقابل حراك دولي أسرع وأكثر وضوحاً. فقد انخرطت عدة دول غربية في زيارات واتصالات مباشرة مع الحكومة السورية الانتقالية، وترافق ذلك مع رفع معظم العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على النظام السابق، إضافة إلى إعلانات صريحة عن دعم المرحلة الانتقالية والدخول في مفاوضات مع الحكومة الانتقالية حول مختلف الملفات.
تعرب المنظمات السورية الموقّعة على هذه الورقة عن ترحيبها بالانفتاح الدولي على سوريا، بما في ذلك العمل على رفع العقوبات الاقتصادية، ونية المجتمع الدولي المساهمة بإعادة إعمار سوريا ودعم التعافي في المرحلة الإنتقالية. كما تعبر المنظمات السورية عن قلقها العميق إزاء الجمود الذي يعتري العملية السياسية الداخلية، وما يرافقه من غياب خطوات ملموسة تعزّز المشاركة العامة، والحوكمة الرشيدة، وتوسيع الحيّز المدني الآمن لممارسة الأنشطة السياسية والاجتماعية. كما تحذر من تداعيات استمرار القيود على الحقوق الأساسية، خاصة في ظل غياب مسارات واضحة وشفافة لتنظيم الحوار الوطني، وصياغة الإعلان الدستوري، وإرساء آليات فعّالة للعدالة الانتقالية.
تقدم المنظمات الموقعة على هذه الورقة رؤيتها على هامش مؤتمر أيام الحوار في دمشق (مؤتمر بروكسل السنوي سابقاً)، وتقدم توصيات لتعزيز المرحلة الانتقالية حول مجموعة من المحاور الرئيسية.
1. الحوار الوطني
بعد أقل من شهر على انعقاد "مؤتمر النصر" الذي أعلنت فيه الفصائل العسكرية المشاركة تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، عُقد مؤتمر الحوار الوطني ضمن إجراءات موجزة تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الشفافية. فقد جرى توجيه الدعوات لعدد كبير من المشاركين/ات قبل ساعات قليلة من انعقاده وبصورة عشوائية، دون اعتماد معايير واضحة لاختيار المشاركين/ات، كما دُعي الأفراد بصفتهم الشخصية دون أي تمثيل فعلي للقوى السياسية والمدنية. يعكس ذلك توجهاً واضحاً نحو تقييد الفضاء العام والحدّ من المشاركة المجتمعية والمدنية والسياسية المنظمة.
كما لم تُؤخذ ملاحظات المشاركين في الغرف الست بعين الاعتبار عند صياغة البيان الختامي لمؤتمر الحوار، ما أوحى بأن الوثيقة كانت مُعدّة مسبقاً وأن المؤتمر اتخذ طابعاً شكلياً لا أكثر. وإضافة إلى عدم إلزامية النقاط الواردة في البيان الختامي، فقد أكد ذلك مجدداً غياب الضمانات الجوهرية للحوار الفعّال والمشاركة الهادفة في صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية.
أخفق مؤتمر الحوار الوطني في بلورة رؤية وطنية جامعة للمرحلة الانتقالية، وفوّت على السوريين/ات فرصة ضرورية لمناقشة الملفات المصيرية المرتبطة بالانتقال السياسي بصورة فعلية وشفافة. كما حُرمت القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية المختلفة من إيصال وجهات نظرها ومطالبها ومخاوفها، ما أدى إلى تغييب التمثيل المتوازن ومنع صياغة مقاربة شاملة تستند إلى المشاركة الواسعة.
كان من شأن حوار حقيقي يأخذ بهذه الاعتبارات أن يعزز الوحدة الوطنية في لحظة انتقالية حساسة، وأن يساهم في تقريب وجهات النظر بين المكوّنات المختلفة، بما يحدّ من احتمالات العنف والنزاعات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية. ومع استمرار هذا القصور في آليات الحوار الوطني وتمثيله، برزت إشكاليات إضافية في الإعلان الدستوري المؤقت الذي يفترض أن يؤسس للمرحلة الانتقالية.
2. الإعلان الدستوري
يستعرض الإعلان الدستوري السوري المؤقت الصادر في آذار/مارس 2025، مساراً دستورياً أُنجز على عجل، وبمعزل عن مشاركة فعلية للسوريين/ات. فقد جاء الإعلان بعد إلغاء العمل بدستور 2012 وإعلان "مؤتمر النصر"، وتشكيل لجنة من سبعة قانونيين لصياغته -يتقاسمون توجهات فكرية متقاربة لا تمثل التنوع السوري القومي والديني، من دون إجراءات شفافة أو نقاش وطني واسع، وبغياب تمثيل سياسي ومجتمعي، ما أضعف شرعيته التأسيسية. كما نشرت مسودات شبه مكتملة له قبل أن تعقد اللجنة اجتماعات فعلية، الأمر الذي عزّز الانطباع بأن الوثيقة صيغت سلفاً وأن اللجنة استخدمت لإضفاء طابع قانوني على نص مُعد مسبقاً.
أبرز ما يميز الإعلان هو التركيز الشديد للسلطة بيد الرئيس الانتقالي بصورة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. فالرئيس يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، تشمل تعيين الحكومة وكبار الموظفين (المادة 35)، وإصدار القوانين والمراسيم (المادتان 36، 39)، والتوقيع النهائي على المعاهدات (المادة 37)، وإعلان الحرب والطوارئ (المادة 41). كما يخوّله الإعلان الإشراف على تشكيل مجلس الشعب عبر لجنة يعيّنها، بينما يعيّن هو مباشرة ثلث أعضاء المجلس (المادة 24)، ما يقيد استقلال السلطة التشريعية ويحوّلها إلى امتداد للسلطة التنفيذية. وتُعيَّن المحكمة الدستورية العليا كاملةً من قِبل الرئيس (المادة 47)، مع استمرار العمل بقانون السلطة القضائية لعام 1961، بما يبقي القضاء خاضعاً للسلطة التنفيذية ويفقده استقلاله. كذلك يَحتكر الرئيس حق اقتراح تعديل الإعلان الدستوري (المادة 50)، ما يعني أن أي إصلاح محتمل يبقى مرهوناً بإرادة السلطة التنفيذية وليس بعملية تشاركية.
على مستوى الشمولية والهوية، يعيد الإعلان إنتاج بنيات الإقصاء القديمة عبر التمسك باسم "الجمهورية العربية السورية" (المادة 1)، واشتراط أن يكون دين الرئيس الإسلام (المادة 3)، واعتماد العربية لغة رسمية وحيدة (المادة 4)، دون الاعتراف باللغات السورية الأخرى كلغات وطنية. وعلى الرغم من ذكر التنوع الثقافي (المادة 7)، لا يقدم الإعلان أي ضمانات فعلية لحماية هذا التنوع أو تمثيله في بنية الدولة. هذه الصياغات، إلى جانب عملية إعداد مغلقة، تدل على استمرار نهج الإقصاء وافتقار التوافق الوطني.
كما يخلو الإعلان من نصوص صريحة حول الديمقراطية أو السيادة الشعبية، ويتجاهل بذلك مبدأ "السيادة للشعب"،هذا الغياب يعلّق المبدأ الأساسي لأي مرحلة انتقالية، ويجعل مستقبل الإطار الدستوري مرهوناً بإرادة السلطة التنفيذية بدلاً من الإرادة الشعبية.
لا يؤسس الإعلان الدستوري بصيغته الحالية لمرحلة انتقالية ديمقراطية، بل يحمل مخاطر إعادة إنتاج السلطة المركزية بلبوس جديد. لذا من الضروري مراجعته جذرياً، عبر تقييد صلاحيات الرئيس، وضمان استقلال القضاء، وتمكين مجلس الشعب من الرقابة والمحاسبة، وتبني مقاربة غير انتقائية للعدالة الانتقالية، وتجريم خطاب الكراهية، وتكريس التعدد القومي والديني واللغوي، وإعادة السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات. بدون هذه المراجعات، يبقى الإعلان إطاراً هشاً لا يعبّر عن تطلعات السوريين/ات ولا يستجيب لشروط الانتقال العادل والشامل. كما يقوض الإعلان الدستوري بوضعه الحالي والصلاحيات الواسعة بيد رئيس المرحلة الانتقالية، مضمون المادة 12 من الإعلان الدستوري ذاته، والتي تتبنى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا. إذ تخالف الصلاحيات الممنوحة لرئيس المرحلة الإنتقالية معظم التزامات سوريا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سواء من ناحية فصل السلطات، استقلال السلطة القضائية، والحريات الأساسية، والتمثيل الفعال لجميع المواطنين.
3. المرسوم رقم (20) ومسار العدالة الانتقالية في سوريا:
صدر المرسوم رقم (20) بتاريخ 17 أيار/مايو 2025 لتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كهيئة مستقلة إدارياً ومالياً، تنفيذاً للمادة (49) من الإعلان الدستوري. ورغم تحديد مهلة ثلاثين يوماً لتشكيلها، لم تُنشأ الهيئة فعلياً إلا بعد ثلاثة أشهر، وما تزال حتى الآن دون هيكلية مكتملة أو نظام داخلي واضح، الأمر الذي يضعف قدرتها على أداء مهامها في مرحلة دقيقة من الانتقال السياسي.
ورغم أن المرسوم أوكل إلى الهيئة مهمة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة المنسوبة للنظام السابق، إلا أنه تجاهل الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها أطراف أخرى في مختلف أنحاء سوريا، وهو ما يشكل خروجاً عن مبدأي المساواة وعدم التمييز، ويُبقي شريحة واسعة من الضحايا خارج تفويض الهيئة. ويؤدي هذا الحصر للولاية إلى تكريس مناخ من الإفلات من العقاب، ما يسمح لمختلف الأطراف والقوى العسكرية التي لا تزال تنشط بشكل مستقل أو تحت مظلة وزارة الدفاع بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، والخطف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والابتزاز والاغتصاب، في مناطق الساحل والسويداء والرقة ودير الزور وغيرها. كما لم يعتمد المرسوم تعريفاً شاملاً للضحايا وفق المعايير الدولية، ولم ينصّ على آليات تشاركية تضمن إشراك الناجين وعائلات المفقودين في رسم أولويات الهيئة، ما يحدّ من شمولية عملها ومصداقيته.
ويزداد القلق إزاء هذا الواقع مع رصد منظمات سورية إطلاق سراح مسؤولين وعناصر متهمين بهذه الانتهاكات، مثل فادي صقر وعدد من أفراد ميليشيا الدفاع الوطني، دون أي توضيح للإجراءات القانونية التي أدت إلى تبرئتهم، رغم الدعوات المتكررة لفتح تحقيقات مستقلة. وأوصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الصادر في 11 آب/أغسطس 2025 حول انتهاكات الساحل، على ضرورة إصلاح النظام القضائي الجنائي ليصبح قادراً على محاكمة الجرائم الخطيرة المرتكبة قبل وبعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في إشارة واضحة إلى غياب الجاهزية المؤسساتية لإطلاق مسار مساءلة فعّال وشامل لجميع الأطراف.
وتفاقمت هذه الإشكاليات مع استحداث وزارة العدل منصب "رئيس العدلية" بصلاحيات واسعة للتحكم بعمل الجهاز القضائي في المحافظات، رغم أن بعض المعيّنين لا يحملون مؤهلاً قانونياً، ما يمثل تدخلاً مباشراً في عمل المحاكم ويقوّض استقلال السلطة القضائية. يضاف إلى ذلك اعتماد الوزارة الأحكام الصادرة عن محاكم شمال سوريا التي أنشئت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، دون التحقق من مدى توافق إجراءاتها مع المعايير السورية والدولية للمحاكمة العادلة، بما يؤدي إلى الاعتراف بمنظومة قضائية موازية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للعدالة. كما يغيب الربط بين عمل الهيئة الوطنية للعدالة الإنتقالية وإصلاح مؤسسات الأمن والجيش والقضاء، رغم أن إصلاح هذه المؤسسات يُعدّ عنصراً حاسماً لمنع تكرار الانتهاكات وتثبيت سيادة القانون.
إضافة لما سبق، يستمر إنعدام التعاون بين الحكومة السورية وآليات العدالة الدولية، إذ لم تُبدِ السلطات حتى الآن موافقة رسمية على مباشرة كلٍّ من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، والمؤسسة الدولية المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا (IIMP)، لعملهما داخل البلاد، رغم التصريحات العامة التي أبدت ترحيباً بجهودهما، ورغم توقيع الهيئة الوطنية للمفقودين وثلاث مؤسسات دولية مختصة بالكشف عن مصير المفقودين إعلاناً حول دور المنظمات الدولية الثلاث في دعم سوريا في معالجة قضية المفقودين.
وتعد هذه الآليات ركائز ضرورية لمسار عدالة انتقالية فعّال، بالنظر إلى اتساع نطاق الانتهاكات وتعذّر قدرة المؤسسات الوطنية على التعامل معها بمفردها. ويؤدي هذا الضعف في التعاون، إلى جانب التأخير في استكمال تشكيل الهيئة وعدم وضوح صلاحياتها، إلى تقويض ثقة الضحايا منذ بداية العملية الانتقالية، في مرحلة كان يفترض فيها أن تستعيد مؤسسات الدولة مصداقيتها عبر تبنّي مسار عدالة انتقالية شامل وملتزم بالمعايير الدولية.
4. النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا:
يمثّل المرسوم رقم (143) لعام 2025، الصادر عن رئيس الجمهورية الانتقالي والخاص بالنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، وثيقة محورية في هذه المرحلة الانتقالية. فقد كان من المفترض أن يشكّل محطة رئيسية في مسار التحول السياسي بعد سنوات النزاع، وأن يفتح الباب أمام انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن إرادة مختلف مكوّنات الشعب السوري. غير أنّ القراءة الدقيقة لنصوصه تكشف عن منظومة انتخابية تعاني خللاً بنيوياً عميقاً، يجعلها بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى من المعايير الدولية للمشاركة السياسية.
يمنح المرسوم رقم (143) لعام 2025 الرئيس سلطة تعيين ثلث الأعضاء، وتعيين اللجنة العليا للانتخابات لتختار بدورها باقي الأعضاء، إضافة إلى تسمية بدلاء عن المنتخبين/ات، يعني أنه قادر على تشكيل أغلبية برلمانية من أشخاص يختارهم بنفسه أو يضمن ولاءهم، ما قد يحوّل المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد ويقوّض مبدأ التعددية الذي تقوم عليه أي عملية ديمقراطية حقيقية.
يضاف إلى ذلك أن الأعضاء الذين يُفترض أنهم منتخبون لا يُختارون عملياً باستقلالية حقيقية، بل عبر سلسلة من اللجان التي تعود هرمياً إلى اللجنة العليا المعيَّنة من قبل الرئيس (المواد 6، 8، 9، 11، 14، 23)، ما يجعل العملية الانتخابية برمتها –إذا جاز استخدام هذا المصطلح في ظل غياب شروط الانتخابات الحقيقية– واقعة في دائرة نفوذه المباشر وغير المباشر. وبذلك، فإن مجمل هذه الترتيبات تجعل "الانتخابات" شكلية، فاقدة لجوهرها كآلية ديمقراطية لضمان التمثيل والمساءلة.
تجعل هذه الصياغة مجلس الشعب عرضة لتوازنات تُصاغ خارج إرادة الناخبين/ات، وتنتقص من طابعه التمثيلي المفترض، إذ تفتح المجال لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة عنها وتعكس الإرادة الشعبية.
يتبنى المرسوم لغة فضفاضة تفتح الباب واسعاً أمام التفسير الانتقائي والإقصائي. فهو يستبعد من الترشح كل من يُعتبر "من داعمي النظام البائد" و"التنظيمات الإرهابية" أو "من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج" (المادة 21 الفقرة 9)، من دون أن يقدّم أي تعريف قانوني لهذه المصطلحات أو يضع معايير موضوعية لإثباتها، مما يحوّل هذه الشروط إلى أدوات بيد السلطة التنفيذية لتحديد من يحق له الترشح ومن يُستبعد، لا بناءً على القانون، بل وفقاً للتفسيرات والاعتبارات السياسية الآنية.
تتناقض أحكام المرسوم (143) مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25)، التي تكفل حق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة والاقتراع العام والمتكافئ في انتخابات حرة ونزيهة. فالاقتراع وفق المرسوم ليس عاماً، بل محصور في هيئات منتقاة، و"الانتخابات" ليست متكافئة بسبب الشروط الإقصائية، والسلطة التنفيذية تحتفظ بسيطرة واسعة على تشكيل مجلس الشعب وإدارة "العملية الانتخابية".
كما تتناقض أحكام المرسوم (143) مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- سيداو (المادة 2، المادة 7)، إذ لا يفي المرسوم (143) بموجبات سوريا وفق اتفاقية سيداو، ويقدم ضمانة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% بدلاً من المساواة التامة، إضافة إلى أنّ تمثيل المرأة والمهجرين وذوي الإعاقة والناجين/ات من الاعتقال، قد صيغت بعبارة "ما أمكن"، ما يجعلها إرشادية وغير ملزمة كما أشرنا سابقاً.
وبذلك، فإن المرسوم (143) لا يتعارض فقط مع المعايير والمعاهدات الدولية، بل يتعارض أيضاً مع الإعلان الدستوري نفسه، الذي يعتبر جميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري (المادة 12).
5. تحديات وخيارات التنمية في سوريا في مرحلة التحول:
على الرغم من توافر فرصة تاريخية لتجاوز إرث الاستبداد وبناء اقتصاد منتج ومستدام قائم على الديمقراطية والتضامن، افتقدت المرحلة الانتقالية المبكرة إلى رؤية تنموية واضحة وآليات صنع قرار تشاركية. وجرى اتخاذ سياسات اقتصادية متعجلة ومنغلقة، من دون حوار مجتمعي أو مؤسسي، ما عطّل تشكيل عقد اجتماعي جديد، وأبقى الاقتصاد رهين قرارات فوقية قصيرة الأجل.
تجلت بنية سلطوية جديدة تعيد تركيز السلطة والثروة لدى دائرة ضيقة، مع استمرار التحيز للمقربين من السلطة، مما يقوض الثقة العامة ويحيل التنمية إلى عملية خاضعة للولاءات لا للمعايير. فقد أفضت السنة الأولى إلى إنشاء أجسامٍ استثنائية مرتبطة بمركز القرار تُبرم تسويات مع ممولي النزاع وتوقّع صفقاتٍ طويلة الأجل في الطاقة والمناطق الحرة والموانئ والمطارات والبنية التحتية، وتطرح مؤسسات عامة للبيع أو للاستثمار من دون سندٍ دستوري أو شفافية أو احترافية تعاقدية.
كما تحوّلت الأصول العامة إلى مصادر ريع لمجموعات نافذة، بعيداً عن الشفافية والمنافسة، وتآكلت العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين المنتجين. هذا المسار يرسّخ نتائج النزاع ويقصي المنافسة، ويحوّل الممتلكات والموارد العامة إلى ريعٍ خاص، ويقيّد الحكومات اللاحقة ببنود استقرار تعاقدي وتحكيم دولي، ويقوّض الحق في التنمية عبر تغييب المشاركة والمساءلة.
أُضعفت قرارات السلطة الجديدة بنية الحكومة البيروقراطية عبر تسريح موظفين وإقصاء الكفاءات، وحلّ محلّهم مقرّبون من السلطة. هذا التفكيك أضرّ بقدرات التخطيط والتنفيذ والرقابة، وأفقد الجهاز الإداري خبرته التراكمية، فتعطّلت سلسلة تقديم الخدمات وتراجعت جودة السياسات العامة.
كما أُزيلت أشكال دعم إنتاجي واستهلاكي وفتحت الأسواق سريعاً ومن دون شبكات أمان أو تنظيم منافسة. وتحمّل المستهلكون والمنتجون الصغار كلفة الصدمات السعرية، وتصاعدت المضاربات والاحتكار، ما فاقم التضخم والفقر وأضعف قاعدة الإنتاج المحلي.
6. توصيات:
في ضوء ما سبق، ترى المنظمات السورية الموقّعة أنّ نجاح المرحلة الانتقالية يتطلّب معالجة جادة للاختلالات البنيوية التي رافقت المسار السياسي الداخلي والعدالة الانتقالية حتى الآن، وتعزيز احترام الحقوق الأساسية، وضمان مشاركة مجتمعية واسعة في صنع القرار. كما تحذر المنظمات الموقعة من التجاهل الدولي لضرورة تصحيح المسار الإنتقالي، مما يسبب بفشل المرحلة الإنتقالية ويهدد بالإنزلاق إلى الاستبداد والعنف.
وبناءً على المعطيات الواردة أعلاه، تقدّم المنظمات الموقعة مجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم مسار الانتقال، وتقوية منظومة المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، وتمتين الأسس الديمقراطية للدولة السورية المقبلة.
1. إعادة فتح مسار الحوار الوطني على أسس شفافة وتشاركية، وبمشاركة سياسية ومدنية واسعة. وإشراك المواطنين في الهيئات المحلية والوطنية بمقاعد ملزمة للنساء والشباب والقطاع المنتج والنقابات.
2. تصميم برامج وطنية للمصالحة المجتمعية تدمج الحوار الأهلي والمبادرات الثقافية والدينية في ترميم النسيج الاجتماعي.
3. مراجعة الإطار الدستوري المؤقت لضمان الفصل بين السلطات، والحد من تركّز الصلاحيات بيد الرئيس الانتقالي، وتعزيز التمثيل الشامل لكافة المكوّنات.
4. تعديل المرسوم رقم (20) لتوسيع ولاية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتشمل ضحايا جميع أطراف النزاع، وضمان استقلالها، وتبني خطة زمنية واضحة ومساراً شفافاً لكشف الحقيقة وجبر الضرر، وردّ الملكيات أو التعويض، وآلية تظلم سريعة للنزاعات العقارية.
5. تعزيز استقلال القضاء، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل المحاكم، ومراجعة قرار وزير العدل السوري بالاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الموازية.
6. تسريع عملية التعاون الرسمي مع الآليات الحقوقية والإنسانية الدولية، بما في ذلك توقيع مذكرات تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة الدولية للمفقودين.
7. ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40% في جميع مؤسسات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك اللجان الدستورية والهيئات الرقابية، وتمكين الشباب في العملية السياسية من خلال برامج تدريب وتمويل مبادرات محلية.
8. تفعيل أجهزة رقابة ومكافحة فساد بصلاحيات إنفاذ، واستبعاد ممولي اقتصاد الحرب من التعاقدات العامة.
9. تطوير رؤية تشاركية تنموية ووقف السياسات الاقتصادية الاجتماعية المعززة للتفاوت وهدر الموارد أو استغلالها، وتبني عملية تعافي اقتصادي تضمينية واحترافية.
المنظمات الموقعة
1. المركز السوري للعدالة والمساءلة
2. المركز السوري لبحوث السياسات
3. العدالة من أجل الحياة
4. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
5. بيل- الأمواج المدنية
6. مركز وصول لحقوق الإنسان
7. حملة من أجل سوريا
8. حقوقيات
9. منظمة ملفات قيصر من أجل العدالة________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.